|
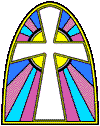


بسم الآب والإبن والروح القدس، الإله الواحد آمين
أعطيت خائفيكَ رايةً تُرفعُ لأجلِ الحق، لكي ينجو أحباؤك
(مز60: 4)
موعظة الجمعة العظيمة 17 نيسان 2009م.
الأب د. يوسف اسطيفان البناء
في كاتدرائية مار أفرام في الموصل

(1)
أيها الأحباء:
على صخرة عند منحدرات الجلجثة جلستُ بالروح قبل أكثر من
ألفي عام، أتأمل صليباً مضرجاً بالدماء، وآثار مسامير، ورقعة
مكتوبة بلغات ثلاث: يسوع الناصري ملك اليهود (يو19: 19)، ذلك
الجليليّ الذي مات بالجسد على الصليب، وأنزل جسده الطاهر ليدفن
في قبر جديد بعد أن اهتزت قوى المسكونة لصلبه واعترفت الكائنات
الحية وظواهر الطبيعة بألوهته من خلال ما جرى يوم صلبه (لو23:
44 – 49)، فعادت بي التأملات إلى معطيات الوحي الإلهي في كتاب
الحياة:
ها هو المرنم المزاميري داود بالوحي الإلهي يطلق عنان
تسابيحه في فضاء السماويات الشاسع، وهو يتأمل البشرية الساقطة
المتعبة، تحاول بين الحين والآخر أن تفتح على المجهول جفنيها
علّها تمسك ببريق أملٍ مما طرق مسامعها من وعد الله للإنسان
الأول بالخلاص، وهي في يأس وقنوط غارقة في متاهات لجة بحرٍ
رهيب من حياة البؤس والشقاء والأوجاع والضياع بعيداً عن الله.
داود وقد تنبه لعلامات السماء تتلاحق مشيرة إلى واسطة
الفداء، يرى بعين الروح أن المستحيل بنظر البشرية سيتحول إلى
عزاء، والعار سيغدو غلبةً وانتماءً، وللمتعبين باب خلاصٍ،
وسلما موصلاً إلى السماء :
داود يرى عصا موسى اليابسة تشق طريقا في البحر، لتكون
أداة خلاصٍ لشعب عاش أجيالاً مرذولاً مهاناً وقد أتعبه العناء
(خر14: 16)؛ ويرى تلك العصا المجردة في رفيديم تروي عطش
التائهين في الصحراء، من جداولَ تنساب بأمر الخالق وعطفه
وحنانه، إذ تفجّر في الصخرة ينابيع ماء (خر17: 5 و 6)؛ ويرى في
برية مارّة شجرة يرميها موسى بأمر الرب في الماء المر فيتحول
إلى أعذب ماء (خر15: 25)، ويرى خشبة منتصبة راية ترفع عليها
حية من نحاس لتكون لكل ملدوغٍ مشرف على الهلاك شفاء (عد21: 9)؛
ويحس بالعصا التي امسكها بيده وهو يقترب من جوليات العاتي، كيف
تبث في نفسه بقدرة رب الجنود إحساساً بالقوة والغلبة على ذلك
الجبار، ليصرعه باسم الرب ويخلص شعبه من ذلك البلاء (1صم17: 40
و 50)؛ داود يبتهج بالروح لكل ذلك وهو يرى بعين الروح ابن داود
بل رب داود في ملء الزمان معلقاً على خشبة ليفتدي الإنسان،
فيتيقن أن واسطة الخلاص ستكون تلك الخشبة ذاتها، التي كانت
تاريخاً ووسماً للدماء، إذ ستغدو بالمسيا المصلوب كفّارة
وفداء، فيصرخ منتعشاً جذلاً بالروح: أعطيت خائفيك راية ترفعُ
لأجل الحق لكي ينجو أحباؤك (مز60: 4).
داود نظر بالروح الخشبة سلم عبور نحو الخلاص، ومصدر
ارتواء للعطاش، وبلسما يحول العلقم إلى عذوبة وطيب المذاق،
وللمدنفين شفاء، وللمستضعفين قوة وبهاء، فأعلنها بارتفاع
الفادي عليها خلاصاً للبشرية من سقطتها وعبورا إلى السماء،
ونبع ماء حي من يشرب منه لا يعطش أبداً، وعلاجاً شافيا لكل
مقبل على الموت بلدغة الخطية، ونكهة عذبة لتذوق حلاوة يسوع
المسيح؛ إنها شجرة الحياة التي تعطي ثمرها في حينه، وأوراقها
لشفاء الأمم، ولا تكون بعدُ لعنةً (رؤ22: 2 و 3)؛ إنها الخشبة
المقدسة التي تضرجت وارتوت بدماء الفادي لتكون راية الحق
والإيمان في العهد الجديد، وأداة الفداء والخلاص للمؤمنين، ذلك
هو الصليب الحي المقدس قبلة المسيحيين.
كم من أعمدةٍ إرتفعت صلبانا، وكم من ألسنةٍ إنطلقت
تتحدّثُ إِفكاً وبهتانا، وكم من مؤرخٍ سطّر ما يشتهي من
ضلالاتٍ بالزور إمعانا، صليب الحقّ وحده كان ميزانا، هو وحده
حملَ من وافانا، فافتدانا؛ عليه ارتفع الكلمة، إلهاً وإنسانا،
إرتفع ليمحوَ الذنوبَ، مقرِّباً ذاته قربانا؛ فعلى الصليب تم
الفداءُ وأهرقَ دمٌ مقدَّسٌ لمن تنازلَ من عليائِهِ يرعانا،
فافتدانا.
بالأمس بلبل الله ألسنةً تجبّرت فتفرقوا في الأرضِ وحدانا
(تك11: 1 – 9)، وعلى الصليبِ لمَّ الشملَ مصالحاً، و( كونوا
واحداً ) بمحبةٍ أوصانا (يو13: 34)، فميزانُ الحقِّ (صليب
الفادي) هو الحدُّ الفاصلُ بين يبسِ الروحِ وما بالنعمةِ
أغنانا؛ وهكذا، مجداً وعِزاً أضحى ما كانَ عاراً وإذلالاً في
عَرفِ دنيانا، وهكذا، الفادي بحنانه ومحبتهِ، فخراً ونصراً
وغلبةً أعطانا، إذ افتدانا؛ فلنبتهج مع داود، مفتخرين بالصليب
مجدِنا ولمسيرتنا عُنوانا، ولنصرخ معه مهللين ومرددين: أعطيت
خائفيك راية ترفع لأجل الحق، لكي ينجو أحباؤك (مز60: 4).
كلمة الصليب عند الهالكين جهالةٌ، وأما عندنا نحن
المخلصينَ فهي قوة الله (1كو1: 18)، كلمة الصليب تتألق في
سمائنا نوراً يضفي ألواناً فألوانا، وتزهو رهبةً لتفجّر في
ضمائرنا بركانا؛ وكلّما ذكرت كلمة الصليبِ سمت لمعاني المحبة
والفداء والخلاص عنوانا، بها نلاطم الأمواج جهاداً، ونشقّ
الطريق للعُلا إيمانا؛ فالصليب في العهد الجديد فجّر ينابيعَ
بالمآثر ملآنة، عزماً واندفاعاً وعطاءً ومحبة وتواضعاً وسهراً
وأتعاباً ودماءَ وظفها المؤمنون شهادة لاسم المسيح وللبيعة
بنيانا.
والصليب علمنا معاني الصبر على الضيقات وتحمل لسعات
النار، فها هو المصلوب منتصبٌ في كل حين أمام الأبصار، فنحن
نكرز بالمسيح مصلوباً (1كو1: 23)، ولم نعزم أن نعرف في الحياة
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً (1كو2: 2)، إذ أنه انتصر على
الصليب ليرفع جبلتنا التي افتداها بدمه من سقطتها وتمرغها في
وحل الدمار، وعلى الصليب دكت أسوار الهاوية وكسرت شوكة الموت
ولحق بالصالبين الخزي والعار، وبذلك نزداد بالإيمان رسوخاً وفي
حروبنا الروحية إصراراً، ويزداد عزمنا في الجهاد أضعافاً، لا
تقدّر بمقدار، لأن الصليب أصبح باب السماء، والطريق به تشعشعً
بالأنوار، وليلنا به خلع ظلمته والدرب أصبحَ في وضح النهار،
وصولاً إلى ميناء السلام، إلى الملكوت، وصولاً إلى أقدس دار.
فكيف يا ترى تم ذلك؟ وما الذي قام به يسوع على الصليب كي
نتمتع نحن بنِعم الصليب؟
هذا ما نتأمله بعد أن نرتل معاً عند أقدام الصليب: وا
حبيبي أي حال أنت فيه؟
---------------------------------
-----------------

(2)
ترى ماذا فعل هذا الناصري العجيب يوم ارتفع على الصليب؟،
فقد صرخ قائلاً: قد أكمل قبل أن يسلم الروح (يو19: 30)، وكان
قد نادى الآب السماوي أن يغفر لصالبيه لأنهم لا يعرفون ماذا
يفعلون (لو23: 34)، حقاً لقد كانت عيونهم مفتوحة لكنهم لا
يبصرون، وبصيرتهم مظلمة لا يدركون، لا يعرفون ماذا يفعلون!!.
في ناموسهم كانوا يحاولون التقرب إلى الله بطقوس وعبادات
رسمت لهم من الله على يد النبي موسى في سيناء، لكنهم كانوا
يطبقون المظاهر فقط، غير مدركين المعاني والدلالات الروحية
والإيمانية لما كانوا يفعلون؛ حتى وهم ينظرون ما حدث على
الصليب يوم ارتفع الفادي الحبيب ، يوم أتم ما كانت تشير إليه
وترمز طقوسهم وعباداتهم، بقيت بصيرتهم عمياء وعقولهم جامدة
ولغتهم خرساء، كانوا لا يدركون.
ابن الله المتجسد يسوع المسيح، ارتفع على الصليب، سفك دمه
الأقدس على الصليب ، وكما أشار يوحنا المعمدان إلى ذلك بقوله:
هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم (يو1: 29)، ارتفع ذبيحة
وتقدمة، مكملاً وبكل إتقان ما كان يحاول الناموس الموسوي أن
يشير إليه ويرمز له (أي ذبيحة الصليب) ومن خلال أنواع الذبائح
والتقدمات المختلفة التي كانت تمارس في العهد القديم بحسب
الشريعة، وهي خمس كما وردت في سفر اللاويين:
ذبيحة المُحرَقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، تقدِمَة
القربان، وذبيحة السَّلامة.
والرب يسوع بارتفاعه على الصليب قدم ذاته ذبيحة حية شملت كل ما
كانت تحاول التعبير عنه تلك الأنواع من الذبائح والتقدمات في
ناموس العهد القديم، فلنتأمل:
1- ذبيحة المحرقة: كانت أولى الذبائح بحسب الناموس الموسوي
التي تقدم لله، وهي تقدمة للرضا أمام الرب (لا1: 3)، ويسميها
الكتاب محرقة وقود، رائحة سرور للرب (لا1: 9)، وتعبّر هذه
الذبيحة عن الطاعة لله، ليكون الله راضياً ومسروراً بعباده
وصنعة يديه، وإذ يرضى الرب على الإنسان من خلال هذه الذبيحة،
يصبح من حق الإنسان أن يقدم بقية الذبائح، فلولا رضا الرب على
الإنسان، لما غفرت الخطايا والآثام، ولما كان نصيب للإنسان
بالإشتراك مع الذبيحة الحية التي تعبر عنها هذه الذبائح، ولما
تمتع الإنسان بالسلام مع الله.
الرب يسوع قرّب ذاته ذبيحة محرقة لله عن البشرية كلها،
فقد عمل خلال وجوده على الأرض بالجسد مشيئة الآب السماوي (يو6:
38)، وأطاع الآب وصولاً إلى أنه أطاع حتى الموت، موت الصليب
(في2: 8)، وقام بذلك عن رضا وقبول ذاتي قائلاً: (لهذا يحبّني
الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضاً، ليس أحد يأخذها مني، بل
أضعها أنا من ذاتي، يو10: 17 و 18)، وبهذه الطاعة من الإبن
للآب، وبهذه المحبة من الآب للإبن، بذبيحة المحرقة على الصليب،
يرضى الله عن الإنسان ويسر به، فقد جاء يسوع إلى العالم
متجسداً محبةً بالعالم ومن أجل العالم كما قال: (أتيت لتكون
لهم حياة، وليكون لهم أفضل، يو10: 10).
هذه الطاعة الرهيبة والعجيبة التي التزم بها الإبن تجاه
الآب على الصليب، إذ أكمل مشيئة الآب قائلاً: (يا أبتاه ....
لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لو22: 42) مع أنه هو والآب واحد
(يو10: 30)، كانت موضع رضا ومسرة للآب السماوي تجاه البشرية
كلها، وهكذا فتح الباب ليقبل الله بقية التقدمات والذبائح عن
البشرية أيضا بشخص يسوع المسيح المصلوب.
2- ذبيحة الخطية: (لا4: 3)، هذه الذبيحة كانت تقدم في الناموس
الموسوي للتخلص من الخطايا التي يرتكِبُها الإنسان تجاه أخيه
الإنسان، وفيها يضع من يقدم الذبيحة يده عليها ويعترف بخطاياه،
فتنتقل خطاياه إلى الذبيحة وتساق الذبيحة للموت عوضا عنه.
وهذا ما قام به الرب يسوع حمل الله الذي حمل خطايا
البشرية كلها مرتفعا ذبيحة خطية على الصليب كما أوضح الرسول
بطرس بقوله: (الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي
نموت عن الخطايا فنحيا للبر، 1بط2: 22)؛ وهكذا البار الذي لا
يعرف خطية حمل خطايانا وصار خطية لأجلنا (2كو5: 21)، ومات على
الصليب لتغفر خطايانا، مات عنا ليحيينا، راضيا بهذه الكأس
المرة التي أرادها أن تعبر عنه لكن بمشيئة الآب (مت26: 39)،
لأن الإبن يعرف أن الآب لا يرضى بالخطية بل يحجب وجهه عنها،
وهذا ما جعل الإبن على الصليب يصرخ إلى الآب السماوي: إلهي
إلهي لماذا تركتني (مت27: 46)؛ وكأني بالإبن القدوس يصرخ إلى
الآب القدوس قائلاً: يا ابتاه لقد حملت خطايا الجنس البشري
كلها لأموت هذه الميتة على الصليب، كي أكون ذبيحة خطية عن
البشرية، لغفران الخطايا.
3- ذبيحة الإثم: (لا5: 15)، ذبيحة الإثم هي الذبيحة التي كانت
تقدم بحسب الشريعة الموسوية كفارة عن خطية الإنسان المباشرة
تجاه الله، أي الخطية تجاه أقداس الله وخيانة بيت الله وإهانة
اسمه القدوس، ولكونها موجهة ضد الله مباشرة فقد أفرز لها
الناموس طقساً خاصاً هو ذبيحة الإثم.
وهذه الذبيحة أيضاً أتمها الرب يسوع على الصليب، إذ صار
هو ذبيحة إثم عوضا عن البشرية التي أخطأت بحق الله وأفسدت
علاقتها بالله، وقد أشار إلى ذلك الوحي الإلهي على لسان النبي
إشعيا قائلاً: (أما الرب فسرّ أن يسحقه بالحُزن، إن جعل نفسه
ذبيحة إثمٍ يرى نسلاً تطول أيامه ومسرّة الربّ بيده تنجح،
إش53: 10)، فالسيد المسيح بتقديم نفسه ذبيحة إثم على الصليب،
صالح البشرية مع الله، وأعاد العلاقة بين الله والإنسان، ولم
يعد يحسب على الإنسان إثم ممّا اقترف ضد أقداس الله.
4- تقدِمَة القربان: (لا2: 1) تتميز هذه التقدمة بحسب الناموس
أنها تشير تماماً إلى طبيعة السيد المسيح، الإله المتجسد،
فالدقيق يشير إلى جسد المسيح، والزيت يشير إلى الروح القدس
الذي جبل منه الجسد في أحشاء العذراء، والذي حل على الرب يوم
عماده في نهر الأردن، واللبان يشير إلى الصلاة والخدمة والعمل
والجهاد، ما أتمه الرب يسوع على الأرض، والنار لاختبار الآلام
الجسدية حتى الصليب، والملح إشارة لعدم الفساد لجسد المسيح
المائت.
وهذه التقدمة كانت ترمز إلى المسؤوليات الجسيمة والخطيرة
التي أتمها الرب بالجسد على الأرض حتى ارتفاعه على الصليب،
ونراها واضحة في حياة الرب حيث تعب وعانى وجاع وعطش وبكى
وجلد، وصولا إلى ارتفاعه على الصليب، ومعاناته وآلامه
الجسدية، وموته وقيامته دون أن يمس جسده فسادٌ (لأنك لن تترك
نفسي في الهاوية، لن تدع تقيّك يرى فساداً، مز16: 10)، فقد
قرّب بذلك ذاته تقدمة قربان على الصليب، مكملاً وجهاً آخر من
أوجه الصليب التي كانت تعبر عنها ذبائح العهد القديم.
5- ذبيحة السلامة: (لا3: 1)، وفي هذه الذبيحة إشارة إلى سفك دم
الرب يسوع على الصليب وتقديمه جسده ودمه عربون حياة للمؤمنين
كهبة سلام للبشرية، حيث الكاهن يرش دم الذبيحة على المذبح، ومن
حق الشعب أن يأكل فقط من هذه الذبيحة وليس من غيرها من الذبائح
والتقدمات التي ذكرناها، إشارة إلى يسوع المسيح الذي قدم ذاته
ذبيحة سلامة على الصليب فسفك دمه الأقدس، ليحق للمؤمنين ومن
خلال حق تناول جسد ودم الرب يسوع اللذين منحهما للمؤمنين عربون
حياة، الإشتراك في نيل السلام الأبدي مع المسيح.
هكذا أيها المؤمنون أكمل الرب يسوع أوجه الصليب الخمسة
التي كانت تشير إليها أنواع الذبائح والتقدمات في العهد
القديم، إذ صار هو ذبيحة الصليب الحية، وهكذا المؤمن المسيحي
في العهد الجديد يشترك مع يسوع في ذبيحة الصليب، لينعم بما
أكمله الفادي على الصليب فيصرخ مع الرسول بولس: (مع المسيح
صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيّ، غل2: 20)،إذ أصبح
المؤمن يتقدم أولاً إلى الله في طاعة كاملة وإرادة صادقة،
واضعاً نصب عينيه طاعة الصليب، ليكون أهلاً أن ينال رضا الرب
ومسرته كي يتمتع ومن خلال ما أتمه الرب يسوع من أوجه أخرى
للصليب بالنعم الإلهية فينال المؤمن غفران الخطايا والآثام،
والشركة في سلام مع الرب.
وهكذا ارتفع الصليب بيسوع المسيح الذي ارتفع عليه، راية لأجل
الحق، محققاً كل ما حاولت ذبائح العهد القديم أن تعبر عنه،
فكان خلاصاً للبشرية، وهذا ما أعلنه المرنم الإلهي بقوله:
(أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق، لكي ينجو أحباؤك، مز60:
4).
وقبل أن نتأمل استحقاقات راية الحق في المؤمنين نرتل معا:
أقبل الفادي لكيما يفتدينا بالصليب.
---------------------------------
-----------------

(3)
أكمل الرب يسوع كل أوجه الصليب وبحسب التدبير الإلهي،
ليعيد للإنسان كرامته ومكانته اللائقة في علاقته بالله من
جديد؛ وبذلك أعطتنا السماء راية ترفع لأجل الحق بها ننجو، بل
أعطتنا سلما حيّاً نستطيع بواسطته أن نصل إلى العلاء، ونعود
إلى حظيرة الآب والخلود المجيد.
ترى ما هي استحقاقات الصليب علينا بعد كل ما تم عليه من
أجلنا؟ فالطريق والحق والحياة، يسوع، يوم ارتفع على الصليب
علمنا أن الإنتماء إليه هو صليب، وان الإنضمام إلى حظيرته هو
صليب، إذ جعل الصليب راية للحق والركن ألأساس في تبعيتنا للنور
والحق، قائلاً: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه
ويتبعني (مت16: 24).
صليب ثقيل نحمله بكل محبة وقناعة ورضا، متحملين معه
الضيقات ومجتازين المعاناة وغالبين هموم الحياة، للإنطلاق
والسمو وراء يسوع نحو السماوات، فقد وُهب لنا لأجل المسيح لا
أن نؤمن فقط بل أن نتألم أيضاً لأجله (في1: 29)، وأن لا نعرف
في العالم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً (1كو2: 2)، ليكون
الصليب نصب أعيننا دائماً في الحياة، وخشبة الصليب نقطة
التقائنا دائما مع الله، وشجرة حياة تؤتينا ثمار انتمائنا
الصادق للمسيح، لا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان
الروح والقوة، لكي لا يكون إيماننا بحكمة الناس بل بقوة الله
(1كو2: 4 و 5).
والكنيسة المقدسة بأبنائها ومنذ العصور المسيحية الأولى
آمنت بهذا المبدأ وطبقته بكل أمانة ورضا ومحبة وسرور، إذ حملت
الصليب بكل ثقله وأوجاعه وأتعابه ومعاناته وسارت وراء يسوع
بخطوات ثابتة عبرت عنها صرخة رسول الأمم المدوية: مع المسيح
صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل2: 20)؛ فملحمة
الصليب فعلٌ إيماني مصدره الكلمة الحق، فيه يتجسد يسوع المسيح
مصلوباً في العالم من جديد كل يوم بهياكلنا ونفوسنا وأجسادنا
من خلال المبادئ الإيمانية والفضائل المسيحية التي نمارسها
بمحبة باذلة نقية وبكل التزام وقداسة وحكمة إنجيلية، مع نبذ كل
ما هو شر وعنف وخطية، رغم كل ما نلاقيه من محن وتحديات، إذ
نتحمل ذلك وصولاً إلى حد سفك الدم وتقديم الذات ذبيحة حية لأسم
رب السماوات.
فالمؤمن يصلب مع المسيح من خلال حياته التي يعيشها على
الأرض، ويصلب نفسه فيها عن كل المغريات والمتاهات والتفاهات
وعن كل ما يبعده عن الرب، ليغلب، إذ لا غلبة للمؤمن إلاّ بحمل
الصليب، ولا انتصار له إلاّ بملحمة الصليب، والسمو براية الحق
من جديد تماما كيسوع الفادي الحبيب.
وهكذا تمتد الكنيسة المقدسة بمؤمنيها في القرن الحادي
والعشرين، فالتواصل اليوم أيها الإخوة مع ملحمة الصليب
الخالدة التي أتمها الرب يسوع لا يصنعه الكلام المنمق المعسول
في الفضائيات، ولا المقابلات التلفزيونية المفبركة وما يحكى في
الندوات، ولا بيانات الإحتجاج الرنانة والتصريحات، ولا تمزيق
وحدة الكنيسة وجسد يسوع الطاهر إلى طوائف متفرقة وأحزاب
متناحرة وتكتلات، ولا الأجساد العارية المقززة تتمايل كالأفاعي
الرقطاء إغراءً وعثرة وتشويهاً للمسيحية في الحفلات، ولا
التراكض والتزاحم والتنافس على مراكز توزيع الخزّ من مال لا
يغني وتفاهة المقتنيات.
ملحمة الصليب تتجسد اليوم بكلمة الله معلنة في الكتاب
المقدس، لكن ليس بحروفه وإنما بروحه، تتجسد في بلوغنا وحدة
الكلمة في وجداننا ووحدة الإيمان في حياتنا، تتجسد بوحدة
الكنيسة في الجهاد الإيماني لأبنائها الإبرار أبطال الإيمان،
مقتدين في ذلك بيسوع المصلوب كي ينالوا الغلبة، يغلبون بروحية
وثبات المطران الشهيد مار بولس فرج رحو وقد تضرجت جثته الهامدة
بالدماء وتلطخت بتراب العراء، إذ سيق كنعجة وديعة إلى الموت،
ضحية تناحر القوى المتسلطة ونزوات التائهين في دروب المغريات
والأحقاد؛ يغلبون بملحمة الصمود الإيمانية للأب الشهيد بولس
اسكندر بهنام وبقية الشهداء ممن فصلت هاماتهم عن الأجساد؛
يغلبون بدماء طاهرة زكية سفكت للشيخ منذر السقا والأب رغيد كني
والأب يوسف عادل عبودي والأخوان هيثم وطارق وبسام وبسمان ووحيد
وعزيز ولينا وسنابل وسالم ووعد .. .. و: (ش، هـ، د، أ، ء) ..
عشرات من شابات وشبان، حملوا بكل فخر فضائل المحبة والوداعة
والتواضع والإيمان، ومزقت أجسادهم بسيل من رصاص الغدر وشظايا
التفجيرات التي أفرزتها سياسات الإحتلال والمخططات الشنعاء.
ملحمة الصليب تتجسد بمئات العوائل التي هجّرت قسراً ونهبت
ممتلكاتها، ودمّرت بيوتها، واضطرّت أن تتنازل عن أتعاب السنين
وعرق الجبين تمسكاً بإيمانها، ومن أجل فضل معرفة المسيح يسوع
ربّها، وهي تصرخ مع الرسول بولس: خسرتُ كل الأشياء، وأنا
أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه ... لأعرفه، وقوة
قيامته، وشركة ألامه، متشبهاً بموته، (في3: 7 – 10).
هكذا يغلب مؤمنو كنيسة الألفية الثالثة للميلاد كبقية
إخوتهم الذين سبقوهم إلى الأمجاد، وجل غايتهم الإنتماء لا إلى
مملكة أرضية دنيوية زائلة، بل إلى مملكة المسيح في السماوات،
المملكة الأبدية التي عرشها مذبح من هامات المعترفين والشهداء
فوق جلجثة الحياة، ورايتها صليب الحق المضرج بدماء زكية لفلذات
الأكباد، وصولجانها حربة تفتح كل يوم جنب الكنيسة ليستمر تدفق
نبع الحياة الذي يلهب قلب كل من يرتوي منه بحب الإنجيل وينير
الأذهان لفهم كلمة الحياة، وتاجها إكليل شوك يدمي الجبين
وتنبعث منه رائحة المسيح الزكية منتشرة في الأجواء، والدخول
إليها من باب ضيقة وطريقها مرصوفة بالأشواك والإهانات، وحمل
صليب ثقيل نرحب معه بالجلدات، في معاناة يتحول معها عرق الجبين
إلى قطرات دم نازفات، وملهمنا في كل ذلك الروح القدس، روح
المعرفة والفهم والمشورة والحكمة ، الذي يرافق كل مؤمن في
مسيرته ليبلغ الحياة الخالدة في الملكوت كما يرضاها الله
ويشاء.
هكذا يكون ملكوت الله حياة حقة يعيشها المؤمنون في
الكنيسة المجاهدة على الأرض (لأن ها ملكوت الله داخلكم، لو17:
21)، وصولاً إلى الكنيسة المنتصرة في السماوات، حيث لا جوع
ولا عطش ولا أتعاب ولا ضيقات، يرعاهم الحمل المذبوح الذي في
وسط عرش السماء، ويقتادهم إلى ينابيع ماءٍ حية، ويمسح الله كل
دمعة من عيونهم (رؤ7: 15 – 17)، فهنيئا لهم إذ تمسكوا براية
الحق، لينجوا من سقطة الممات.
نرفع الأكف إلى الفادي يسوع في هذا اليوم المبارك، ونحن
نستذكر يوم الصلبوت العظيم، أن يرحمنا برحمته ومحبته وعطفة
وحنانه، وينقذنا من الضيقات والمحن التي نمر بها، ويحل الأمن
والسلام في قلوبنا وربوعنا وبلادنا، ويرحم شهدائنا وأمواتنا،
بجاه راية الحق التي ارتفع عليها لينقذنا، الصليب المقدس، إنه
السميع المجيب، آمين.
-----------------------------------------------
---------------------------------
-----------------
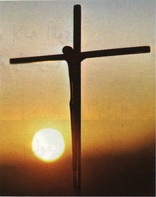



إذهب الى
الموعظة الأولـى

إذهب الى
الموعظة الثانية

إذهب الى
الموعظة الثالثة
العودة للصفحة السابقة
|