في البدء أروي واقعة مؤلمة صادفتني في مسيرة حياتي
الكهنوتية .......
في صفوف الطلبة الذين هيأتُهم للمناولة الأولى، انضمّ ثلاثة
أخوة، ثلاثتهم في المرحلة الإعدادية وأخذوا أمكنتهم بين
الطلبة. وبعد أيام عديدة من التعليم فاجأتني والدتهم
بقولها إنها تنوي السفر إلى إحدى دول الجوار لتسجّل اسمها
ضمن مفوضية اللاجئين لغرض الهجرة، فقلتُ لها:"أيتها السيدة
المحترمة، إن أولادكِ حتى هذا العمر لم يتقدموا من
المناولة الأولى، ولم يبقَ على موعد الإحتفال بالمناولة
الأولى إلاّ أسبوعاً واحداً. وافرضي أنّه فُرِضَ منع
التجوال أو تأخر صدور الجواز أياماً وأياماً و... و..."
فلم ينفع هذا الكلام. وفي اليوم التالي كان الطلاب غائبين
عن الدوام... لقد سافروا!.
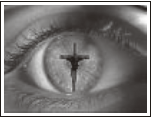
تألمتُ كثيراً وقلتُ في نفسي:"هل نحن فعلاً ننتمي إلى المسيح،
أم إن المسيح لنا كَمُرافِقٍ، يسير معنا على الهامش أم
يرافقنا ليس إلاّ؟ لماذا عليه أن يكون مستعداً حينما
نحتاجه وندعوه، ولا نبالي به إذا ما أصدرت دنيا زمننا
أوامرها...!!!.
من سنوات طويلة نلنا العماد المقدس، والمعمودية زرعَتْني
بالمسيح الجفنة وهي تشدّني دوماً إليه وتوصلني به، وإن
باقي الأسرار تغذّي إتحادي بالمسيح وتجعل حياته تتدفق من
خلال أعمالي وأقوالي.
نعم "إن المعمودية تُشركنا في غلبة المسيح" (كو 14:11)، فهي
تُدخل المؤمن في سرّ موت وقيامة المسيح. فمن جهة يَدخل
المعمَّد إلى جرن العماد بعد أن يكون قد اعترف بأن إنسانه
العتيق هو إنسانٌ مستَعبَد لقوة الموت والخطيئة، وبأنّ
أحداً لم يقدر أن يحرّره من قوة الخطيئة هذه، وبذلك يرتضي
أن يُدفَن هذا الإنسان العتيق في مياه المعمودية متمثّلاً
بذلك بموت المسيح على الصليب. وموت الإنسان العتيق يعني
التحرّر من كل القيود والديون التي عليه لله بسبب خطاياه
00 ومن جهة أخرى يخرج المعمَّد من جرن المعمودية لابساً
إنساناً جديداً هو على صورة المسيح القائم من الموت، هذا
الإنسان الجديد لم يعد للموت عليه من سلطان، وبالتالي لم
يعد مستَعبَداً للخطيئة الناتجة عن خوف الإنسان من الموت.
إن ايماننا الذي اصطبغنا به في العماد يجعلنا أن نعلن
المسيح وحده هو الرب، هو وحده القادر أن يحررنا من خوفنا
وقلقنا، إنه وحده الذي يعطي السلام لقلوبنا ويغلب موتنا
ويبشّرنا في الحياة التي لا تفنى.
إن الإيمان هو تلبية لبشرى الخلاص التي يعلنها الرسل ويعلنها
بولس (رو14:10-15)، كما إنه اختبار لقدرة الله في مغفرة
الخطايا وفي إعطاء حياة جديدة بروح يسوع المسيح القائم من
الموت (1قو 1:2-5).
كما هو الإختبار عينه الذي عاشه الرسل في العَنصرة بنوالهم
الروح القدس الذي حرّرهم من الخوف، وعاشه بولس ودعاه
ليبشّر به كل الأمم، وهو الإختبار عينه الذي يعيشه كل
إنسان يعترف بأنه غير قادر على تخليص نفسه مهما عَظُمَت
أعماله.
إن المؤمنين بعمادهم _ بإيمانهم يشتركون في ملء المسيح بكونهم
أعضاء حية في جسده السري، فيصبحون بإتحادهم بالمسيح أسمى
من الرئاسات والسلاطين والقوات السماوية كافة.
عالمنا اليوم هو تجسيد حيّ "للأمس"، والمنطق السائد في
أيامنا هو إننا لا نستطيع أن نسير بعكس التيار، نسير "سيرة
هذا العالم" الذي عاد إلى الوثنية، مبرّرين أنفسنا بعدم
القدرة على مواجهة العالم، ولا أحد ينكر أن سيد هذا العالم
قوي جداً. وقد ازدادت أساليب إقناعه قوةً بفضل التكنولوجيا
الحديثة وليس لأن هذه بحد ذاتها شريرة، بل لأن أبناء هذا
العالم يستغلوننا أفضل إستغلال. كما إن إنسان اليوم يُقصَف
كل يوم بمئات بل بآلاف التعاليم الآتية من كل حدب وصوب
وبكل وسيلة. وكثيرون هم الذين ابتعدوا عن الإيمان أو
فقدوه، واعتقدوا أن ما كان محرَّماً بالأمس قد صار
محلَّلاً اليوم.
كما إن إنسان اليوم واقف أمام المصائب والأحزان، وفي خضمّ
البلايا والرزايا، وعند فقدان أيّ عزيز من العائلة أو في
الرعية، أو يصاب آخر بمكروه، أو ينهش المرض العضال أحد
الغاليين فيبلغ الجرح الصميم وتنقطع الأوصال.
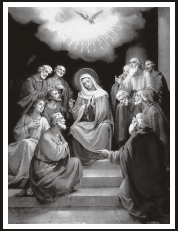
ولكن الله، كما بالأمس كذلك اليوم، يحبّ هذا العالم، يحنو عليه،
يشفق على موته، ويرغب في تمليصه من سلطان إبليس. إن المسيح
الذي دعانا للتبشير باسمه ولطرد الشياطين وشفاء المرضى
ونشر ملكوته، هو نفسه حاضر في كل أعمالنا، ويدعونا أن نملأ
فراغ حياتنا من معجنه ومن أسراره كي نعيش إختباراً حقيقياً
لموت وقيامة المسيح، وبالتالي نكون شهوداً لمجيئه. وأن لا
تكون الكلمات التي نرددها في فعل إيماننا "وننتظر مجيئكَ
الثاني" تكراراً لكلمات تعلّمناها وحفظناها، وفقدت
فاعليتها في حياتنا ونفوسنا. بعض الناس يهربون من الموت
بواسطة التسلية أو إضاغة الوقت أو إشغال ذاتهم بالأعمال
والمشاريع. وبعضهم يعتقدون أن معرفة المستقبل تنجّيهم من
مخاطر، وأخرى تؤدي بهم إلى الموت. ليطمئنوا على مصيرهم
وغدهم فتراهم يتوجهون الى عبور المحيطات.
إن المسيحية لا تنتهي مطلقاً عند أقدام الصليب، كما إنها لا
تحاول أن تمجّد العذاب والآلام. المسيحية تعرف وترجو من
أنّ ما وراء حجاب الجمعة الكثيف ستشرق شمس الأحد "وفي
اليوم الثالث يقوم" 00 هذه هي كلمة إيماننا الثابتة،
نعلنها دوماً بعد تأكيدنا على أنه تألّم ومات وقُبِر.
لقد أطلق النبي حاجاي (7:1) في القرن السادس قبل الميلاد
صرخته الجارحة:"فكّروا في مصيركم"، ونحن نعلم أن الرب علّق
مصيره على الصليب، وإن على المؤمنين أن يربطوا مصيرهم
بمصيره (لو17). فعلى الرغم من كل ما يحيطنا من غموض وأسرار
في هذه الحياة، كما كانت حال الإثني عشر بالتمام، سنتذكّر
دوماً نهاية هذا الإنجيل "وكان هذا الكلام مغلقاً عليهم
فلم يدركوا ما قيل".
إذن، حياة الرب يسوع هي لنا أكثر من برنامج حياة، إنها ينبوع
صمود وثبات. على نور حياة الرب وهدي كلماته نقوى على
التجربة، ونجتاز العتمات بقلب مصالح، ونرى على أنوار صليب
المسيح إن الفشل الظاهر هو درب إلى الإنتصار، لذا علينا أن
نواجه الخيبة بالرجاء، وأخطار التجارب بصمود وثبات، ونتأكد
من أننا بإتحادنا بال نستطيع أن نعمل ما عمل هو وأكثر.
لم أفهم يوماً أكثر مما أفهمه في هذه الأيام، ما قاله البابا
بيوس الثاني عشر:"خطيئة إنسان اليوم الكبيرة هي أنه فقد
معنى الخطيئة". لهذا أصرخ مع صاحب المزمور: إني بائس
ومسكين، "فليعضدني خلاصك يا الله" (مز 3:68). هناك خبرتان
يختبرهما الإنسان طوال حياته: خبرة إيجابية من الإنسجام مع
ذاته ومع الآخرين ومع الكون، وخبرة سلبية مع النقص في ذاته
وفي المجتمع وفي الكون. لذلك يقضي الإنسان حياته منقلباً
بين الفرح والحزن، بين الصحة والمرض، بين السلام والحرب،
بين السعادة والشقاء.
جميع الناس يدركون بؤس الإنسان وضعفه وقلقه، ولكن المؤمن وحده
ينظر إلى الله ويقول:"إني بائس، فليعضدني خلاصك يا الله".
لذا فالمؤمن يرى أن سبب حالة الإنسان هذه هو بُعده عن
الله، لأن الإنسان خُلِقَ لأجل الله، فإن ابتعد عن الله
إنما يبتعد عن ذاته وينفصل عن جوهره ويفقد هويته 00 لقد
إنحنى الله على البشر عندما أخذ تراباً وجبله وخلق
الإنسان، ثم إنحنى عليهم عندما كلّمهم بواسطة الأنبياء.
ولما بلغ ملء الزمان إنحنى عليهم في شخص إبنه يسوع المسيح
الذي جاء مخلِّصاً للإنسان في تجسده وموته ونزوله إلى
الجحيم وقيامته. سرّ حضور الله فينا بيسوع المسيح كشف عن
وجه الله وخلق الإنسان الجديد، وهذه دعوة لنا أن نرسم طريق
إنتمائنا إلى المخلّص الذي آمنّا به عبر جرن العماد.
فالمسيرة بدأت في صغرنا، ومواصلة مسيرتها الإيمانية يعني
وفاءنا للوَزنة التي أؤتُمِنّا عليها 00 المسيح لا يحتاجنا
عدداً أو كميةً إنما يريدنا أن نكون واحداً معه، أي أن
نذوب فيه، أي أن نموت فيه لنحيا للآخر.
فالإنتماء لا يكون واضحاً وجلياً وأكيداً إلا في زمن الشدة
والإضطهاد. فالحياة مسيرة الإيمان، والوفاء لهذا الإيمان،
محرار قياسه يبدأ عبر طريق الجلجلة ويسجّل الدرجة النهائية
على الجبل. ولكن كل شيء يتجدد في اليوم الثالث بالقيامة،
ويبقى هذا الحدث حدثاً إيمانياً نحياه في القلوب من أجل
الآخرين. فانتماؤنا إلى المسيح يجب أن يكون انتماءً كلياً
... أما أنتَ فاذهب وبشّر بملكوت الله (لو 60:9) ولا شيء
آخر.